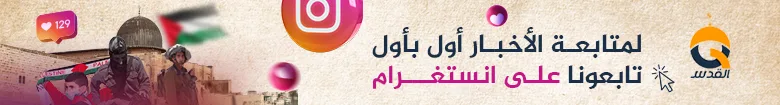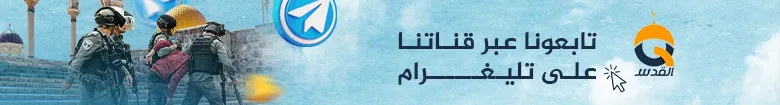الضحية المُلهِمة

– من خيانة التاريخ، إلى إرهاق الجغرافيا، إلى الانفصال التام بين الهتاف والقدرة –
نعيش نحن الفلسطينيون، لحظة سياسية مريضة. نكاد نرى فيها أنفسنا بالعين ذاتها التي يرانا بها الغريب: مشهد يتكرّر حتى يفقد أثره، وصورة تُستهلك حتى تبهت. كل شيء يوحي بأننا “منخرطون” — لكن الحقيقة أننا فقدنا القدرة على الفعل، إلا من رحم ربي.
في الداخل، تمكّن الكيان من صناعة “نسخة داجنة” من الفلسطيني الأصلي؛ فلسطيني يصوت، ويعمل، ويُظهر اعتراضه بلطف، ويعتذر عن أي “حدة لفظية”. كل هذا في ظلّ سلطة تنام على أسطوانة “التمثيل السياسي”، وأحزاب أليفة تتحدث عن “التأثير من الداخل“، بينما يواصل الاحتلال ابتلاعنا أحياء. تم تفريغ القضية من محتواها، وتحويلها إلى خيار ثقافي.
في الضفة يُشيّع الشهيد صباحًا، وتُوقّع الاتفاقيات مساءً.
يُعتقل المقاوم، وتُدان الضحية، ويُنسَّق القمع بتقنية بيروقراطية تُسمى “تفاهمات”. وهكذا، لا يكتفي النظام القائم بإخضاع الجسد الفلسطيني، بل يمعن في نفي روحه، وسحب المعنى من موته ويستمر باستغلال الفلسطيني، أرضاً وروحاً وجسدا حتى بعد الممات.
ما نعيشه اليوم ليس صمتًا، بل شكل من الانسحاب الطوعي من الوجود السياسي. انسحاب صاغته سنوات من الاستنزاف والتلاعب والتسويات. انسحاب لم يأتِ من هزيمة واحدة، بل من تكرار الهزائم حتى تحوّلت إلى واقع مألوف، ثم إلى بنية نفسية. وعندما نفقد القدرة على التأثير، نغرق في تأويل الرموز.
التدجين الرمزي
في علم الاجتماع السياسي، هناك مفهوم مركزي يسمّى إنتاج المعنى تحت الهيمنة. لا تكتفي القوى المسيطرة بقهر الضحية ماديًا، بل تسعى أيضًا إلى احتلال لغته، وإعادة صياغة إدراكه لذاته وللعالم. ما نراه اليوم في الحالة الفلسطينية هو تجسيد دقيق لهذا النموذج: تحويل الفلسطيني من فاعل سياسي إلى رمز دلالي. من شخص يواجه الظلم إلى صورة تُستهلك في الإعلام.
في هذا السياق، تتقاطع أدوار السلطة، والمنظومة الاستعمارية، والإعلام الدولي، والنخبة المحلية المُروّضة. كلهم يساهمون في تدجين الصوت الفلسطيني ضمن حدود ما يمكن قبوله عالميًا. تُصرخ امرأة تحت القصف، فيُقال لها: “أحسنتِ، لقد وصل صوتك”، ثم تُفصل الحادثة عن سياقها وعن معناها السياسي وتُعاد تعبئتها كمنتج بصري.
هذا ما يسمّيه باحثو علم النفس الجمعي بـ**”أثر الانفصال الإدراكي للصدمة”**. حين تتكرر الصدمة، وتفقد فعاليتها في تحشيد أي نتيجة ملموسة، يبدأ الدماغ الجمعي بالانفصال عنها لا ليقاوم، بل ليحتمي. نتحوّل لا شعوريًا من مشاركين إلى مراقبين، من منخرطين إلى محلّلين. هو سلوك بقاء، لكنه أيضًا بوابة زوال.
أما من منظور ما بعد الكولونيالية، فالحالة الفلسطينية تُجسّد بوضوح ما يُعرف بـ**”التغريب داخل الذات”**: حين يبدأ المقهور بتبنّي لغة القاهر، ومنطقه، ومقاييسه للبطولة، وحتى معاييره للمظلومية. يتحدث الفلسطيني عن نفسه كما يريد الآخر أن يسمعه. وبذلك، لا يُهزم فقط في ميدانه، بل يُعاد تشكيله عقله.
إن كان التاريخ يعيد نفسه بالنكبات المتوالية، فلماذا لا يعيد نفسه في النضال؟
إن أخطر ما نواجهه اليوم ليس القمع المباشر، بل قدرة النظام الكولونيالي على إقناعنا بالتعايش مع القهر كخيار معقول، وتحويل الاستسلام إلى “واقعية سياسية”، وتسويق الجمود كـ توازن مطلوب.
نحن أمام مشهد عفن وسأم، لا ينقصه البكاء، بل الخيال السياسي الجماعي.
ما نحتاجه اليوم ليس اختراعًا من العدم، بل استعادةٌ ذكية لذاكرة الفعل الجماعي، خارج منطق الفصائل المنهكة، وخارج هندسة الانقسام التي زرعها العدو وتبنّتها النخب.
المطلوب ليس وحدة شكلية، بل رصّ واعٍ للصف الفلسطيني على قاعدة التحرر لا السلطة، وعلى أولوية الإنسان لا المنصب.
رصّ يبدأ بتعريف من هو “الصف”، ومن هم شركاء القضية، ويعيد ترتيب الأولويات: من التمثيل إلى التحرير، من الردود الإعلامية إلى الفعل الميداني، من النحيب إلى التنظيم.
حتى لو أن الدعوة إلى “الوحدة” باتت شعارًا مكرورًا؛ فالواجب اليوم أن نعيد تعريفها لا كحالة مؤسسية، بل كممارسة يومية، وخلق مساحات فعل جديدة خارج الأطر المتكلّسة
هزار حسين
حيفا | فلسطين المُحتلة.