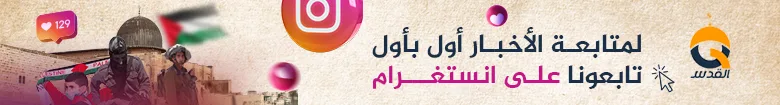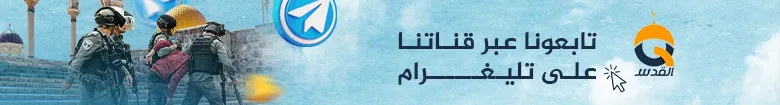السؤال القادم من الشرق

ماذا يعني أن نقرأ الغرب من الشرق
معركة التأويل ضد الرواية الغالبة.
في قلب كل قراءة نقدية، وفي صُلب كل قراءة تُراجِع أدوات النقد ذاتها، يكمن وعي يتجاوز النصوص وحدودها؛ فالنقد ليس مجرد تفكيك للخطاب، بل هو فعل تأملي في شروط المعرفة وسياقات إنتاجها. أما “نقد النقد”، فهو أكثر من مراجعة منهجية، هو فعل مقاومة معرفية، يفتح المجال لإعادة التفكير في الأدوات والمفاهيم التي نظنّ أنها محايدة.
في هذه الدوامات الفكرية، لا يكون الهدف هو الوصول إلى “حقيقة” نهائية، إنما توسيع أفق الفهم، وكشف البُنى الخفيّة التي تشكّل وعينا.
أن تقرأ الغرب من الشرق، هو أن تقرأه بعينٍ مثقلة بذاكرة الجرح، وأن تلتقط المعاني من صدوع الأعمار التي هدمتها آلة الحداثة و اصداء «الاستعمار التقدّمي» ؛ فيما يقرأ الغرب ذاته دوماً في موقع المُفسّر، المُنقّب، المتأمّل، المقرِّر لماهية الآخر. أما قراءة الشرق، فتبقى غالباً حبيسة ثنائية: الولع أو الرفض الكامل.
انعكاس المواقع
ثمّة ما هو أبعد من الجغرافيا حين نتأمّل علاقة الباحث بالموضوع الذي يدرسه.
فأذا نظرنا الى عملية التفاعل بين الثقافات على أنها “تموضع معرفي متبادل”. فكما يشير المصطلح، لا يتم النظر إلى الثقافات على أنها كيانات مستقلة تتفاعل مع بعضها بمعزل عن سياقاتها الاجتماعية والسياسية والتاريخية. بل هي عمليات تفاعلية تتبدل وتتطور بناءً على فهم كل طرف للآخر، وبشكل متبادل يساهم فيه كل منهما في تشكيل الآخر؛ و بما أن “الاستشراق” كمصطلح نشأ من تموضع الغرب مقابل الشرق، فماذا لو انعكست المواقع؟
لو انعكست الجغرافيا والقوة، وكان الشرق هو المُهيمن والمُنتِج للمعرفة عن الغرب، لربما كنا أمام ”استغراب“ كمنظومة فكرية مقابلة، أي طريقة الشرق في تخيّل وتمثيل الغرب، ولكن بشروط الهيمنة والنظرة الفوقية.
فقد عرف الغرب عرف نفسه كغرب من خلال التمايز عن الشرق الذي تصوره من خلال الاستشراق، وبالتالي أي تصور للغرب كغرب هو نتاج الاستشراق أو ضالع فيه- وبالتالي نقد الحداثة الغربية، ونقد الاستغراب، هو في النهاية نقد الاستشراق أو على الأقل لا ينفصل عنه.
وهنا تكتسب قراءة جوزيف مسعد أهمية استثنائية؛ ليس فقط بوصفها امتدادًا لخط إدوارد سعيد في نقد الاستشراق، بل لأنها تجرؤ على الذهاب أبعد: إلى نقد الحداثة نفسها، وإلى التشكيك في براءة الأدوات الليبرالية والعلمانية التي وُلدت في الغرب وتُصدَّر للعالم كمسلّمات.
في كتابه “اشتهاء العرب”، يستعرض مسعد كيف أن الخطاب الغربي الحديث لا يقتصر على تصوير الشرق كموضوع استشراقي، بل يشكل هذه الصورة في زمن تحولات عالمية عميقة يرافقها استغراب متزايد — أي محاولة الشرق لفهم الغرب، لكن ضمن إطار الاستعمار الفكري والثقافي الذي يفرضه الغرب نفسه، وبهذا يعيد إنتاج دائرة الهيمنة. هذا يشير إلى أن العلاقة ليست أحادية بل معقدة تتقاطع فيها عمليات الاستشراق والاستغراب في آنٍ معًا، لتخلق سرديات متداخلة من الهيمنة والمعارضة.
تبرز قراءة جوزيف مسعد كمثال هام لفحص حدود النقد والنقد الذاتي في سياق الهوية والتاريخ. إذ يتناول إشكاليات الثقافة والسلطة من زاوية مغايرة، ويعيد طرح الأسئلة التي تشغلنا حول العديد من المسائل المعرفية والوجودية.
و النقد هنا هو نقد بنيوي لا يقتصر على خطاب محدد أو مشروع استعماري بعينه، بل نقد للنظام الفكري بأكمله الذي يُنتج هذه الخطابات ويشرعنها. كما أنه لا يقتصر على تحليل الخطاب أو تفكيك النصوص، بل هو فعل سياسي ومعرفي متداخل يتصل بسياقات السلطة والهُوية والمعرفة.
بهذا المعنى، يمثل فكر جوزيف مسعد مثالاً حيًا على النقد الذي يتجاوز حدود الاستشراق التقليدي ليصل إلى نقد الحداثة الغربية برمّتها؛ التي تُروّج لها الليبرالية، كأمر عالمي أو حتمي؛ في محاضرته “الاستغراب هو الاستشراق”، يؤكد مسعد أن هذا الانعكاس لا يغير من جوهر الأمر، بل يوضح كيف أن أي إنتاج معرفي لا يخلو من علاقات قوة، وأن استغراب الشرق للغرب لا يتخلص من أساليب السيطرة المعرفية، بل يعيد إنتاجها بتصميمات جديدة. وهكذا تصبح العلاقة بين الشرق والغرب؛ دائرة متشابكة من التمثيلات المتبادلة.
هذا الثراء الفكري يجعل من مسعد شخصية محورية لفهم تطور الفكر النقدي العربي في مواجهة الهيمنة الغربية؛ إذ لا تعود المسألة مجرّد نقد للاستشراق، بل تصبح مواجهةً مع بنية المعرفة الحديثة التي تصوغ العلاقة بين المركز والهامش، بين المعرّف والمُعرَّف، بين الكاتب وموضوع الكتابة.
إذا كانت الكتابة النقدية تبدأ عادة من تفكيك ما هو مهيمن، فإن مشروع جوزيف مسعد لا يكتفي بتفكيك الخطاب الاستشراقي وتحيزاته، بل يذهب إلى تفكيك علاقة الشرق نفسه بمفاهيم الغرب عنه. لا يكتب مسعد من موقع “الضحية” الذي يطالب بإعادة الاعتبار، بل من موقع الناقد للعبة الاعتبار ذاتها.
في كتابه “الإسلام في الليبرالية”، يسائل مسعد المشروع الليبرالي الغربي في صيغته الكونية، ويُظهر كيف أن مفاهيم مثل “حقوق الإنسان”، “التحرر الجنسي”، “الديمقراطية”، وحتى “العقلانية”، ليست مفاهيم بريئة أو محايدة، بل مشاريع أيديولوجية يتم توظيفها لاختراق الثقافات غير الغربية، وإعادة إنتاج الهيمنة بأدوات أخلاقية.
وهنا أقتبس؛
“The universalizing mission of liberalism, especially when exported through the language of human rights, functions as a civilizing mission no less than that of colonial Christianity in the 19th century.”
(Joseph Massad, Islam in Liberalism, University of Chicago Press, 2015, p. 38).
استشراق ولكن!
لقد أتاح موقع إدوارد سعيد “الغربي” له أن يشخّص تلك النظرة الفوقيّة للشرق، لا لأن “الغرب” هو وحده من ينظر، بل لأنه هو نفسه كان يقف بين الضفّتين، يرى الفجوة ويملك لغتين، ووعيين، وسياقين. لكن وائل حلاق، وهو من موقعٍ آخر، رأى أن هذا التشخيص نفسه ينطوي على إشكال، إذ إن أدوات سعيد ـ العلمانية، الليبرالية، والنظرة الثقافوية ـ كانت لا تزال متأثرة بمنهج الغرب في فهم الدين والإنسان. حلاق، رغم حدّته أحيانًا، نبّه إلى أن نقد الاستشراق لا يُعفي الناقد من أن يكون جزءًا من بنيته.
كان جوزيف مسعد أحد طلاب إدوارد سعيد في جامعة كولومبيا، وأصبح أحد أبرز المفكرين الذين يواصلون إسهاماته في نقد الاستشراق، لكن جوزيف مسعد لم يقف عند حدود قراءة سعيد، بل قام بتطوير مواقف أكثر راديكالية، واستخدم مفاهيم سعيد لفتح نقاشات أعمق حول الصهيونية والاستعمار الجديد.
ففي حين كان سعيد يعتبر الصهيونية مشروعًا استعماريًا يعيد تشكيل العلاقات بين الفلسطينيين واليهود، ذهب مسعد إلى حيث اعتبر أن الصهيونية لا تقتصر على كونها مشروعًا استعماريًا ضد الفلسطينيين فحسب، وهو موقف يتجاوز تحليلات سعيد التي كانت أكثر إنسانية في نقدها لهذا المشروع. وقام بتوسيع هذا النقد ليشمل تحليلًا للأيديولوجيات العنصرية التي انتشرت في أوروبا والتي تبنتها الحركة الصهيونية لتبرير استيطانها في فلسطين. هذا التحليل في نظر مسعد يفتح الباب لفهم كيف يمكن للفكر الاستعماري أن يُعيد تشكيل الهويات الوطنية والقومية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على المستوى الدولي، مما يجعل القضية الفلسطينية رأس الحربة في النضال ضد الاستعمار بكل أشكاله.
وفيما فيما يعتبر سعيد ومسعد ال صهيونية مشروع عنصري ومعادٍ للسامية؛ يبرز بوضوح موقف مسعد مع المقاومة مقابل الموقف المتردد لسعيد حيالها.
ظاهرة الغرب الحداثي
يتقاطع جوزيف مسعد بنقده الحداثة الغربية مع مواقف وائل حلاق، إذ يطرح فكرة أن الاستشراق ليس فقط مشروعًا استعماريا تقليديًا، بل هو أيضًا جزء من مشروع حداثي أوسع يشمل سعي الغرب لتشكيل وتوجيه المجتمعات الشرقية بما يتماشى مع معايير الغرب الحديثة والعلمانية.
وهو نقد موجه بالأساس إلى النظريات الغربية التي تروج لفكرة الحتمية التاريخية، والتي تتصور أن المجتمعات الإسلامية يجب أن تتبع نفس المسار التاريخي الذي سار فيه الغرب، المقتنع بان الحداثة تساوي اللا إسلامية.
تناول مسعد في عمله “الإسلام في الليبرالية” مسألة الحداثة الغربية، محاولًا إظهار كيف يتم استخدام الإسلام كأداة في الخطاب الغربي الليبرالي، ليُقنن التدخلات السياسية والثقافية في الدول الإسلامية.ويشير لمساعي الغرب لإخضِاع الآخر لصورته عنه، لا لذاته كما هي. أي أن القراءة الغربية للشرق ليست فقط متحيّزة، بل تُفرض على الشرق أن يقرأ نفسه بها.
و لا يقتصر النقد هنا على فكرة التدخل الغربي فقط، بل يتعداها ليشمل طريقة تصوّر الغرب للعالم الإسلامي ككيان ماضوي وغير قادر على التكيف مع التقدم والتحديث الذي يراه الغرب مرجعية حضارية.
بهذا، يتفق مسعد وحلاق في رفض فكرة “الحتمية الغربية” في النمو والتقدم، إلا أنهما يختلفان في طريقة تصورهما لهذه الهيمنة.
الاتفاق بالرفض والاختلاف بالتأصيل
مسعد وحلاق يشتركان في رفض الحداثة الغربية والعلمانية، إلا أن مسارات نقدهم تختلف في عمق تأصيل هذا الرفض.
حلاق يرى أن المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن تُقلد النموذج الغربي لأن هذا النموذج نفسه يحتوي على تناقضات أساسية تؤدي إلى فشل محاولات محاكاته في الشرق.
فيما يعتبرها مسعد أيديولوجية تفرض نمط حياة معين وتُستعمل كأداة للقضاء على الهويات الدينية والثقافية.
تمتد هذه الانتقادات إلى النقاشات التي تدور حول الإسلام والحداثة. في أعماله، يكشف مسعد عن تناقضات جوهرية لا يمكن اختزالها في نزاع فكري بين ديني وعلماني.
هذا التفكيك لا يعني إنكار وجود انتهاكات في المجتمعات الشرقية، بل يعني فضح الكيفية التي يتم بها توظيف تلك الانتهاكات لتبرير خطاب استعلائي يُعيد إنتاج علاقة المستعمِر بالمستعمَر، فحين يُقدَّم “تحرير المرأة المسلمة” مثلًا كواجب ليبرالي غربي، يصبح جسد المرأة الشرقية مرة أخرى ساحةً للهيمنة الخطابية والسياسية، لا موضوعًا للكرامة أو الحرية الفعلية.
لذا، تكتسب قراءات سعيد وحلاق ومسعد أهميتها، لا بوصفها نصوصًا أكاديمية فقط، بل كنماذج لكيفية التفكير في الذات والآخر، في شروط المعرفة ومآلاتها، في الحقول التي تُزرع فيها الأسئلة، لا الأجوبة. كما أن هذه الدراسات تقدم أدوات فكرية لفك رموز التبعية الثقافية والنقد الاستعماري؛ وإن تأصيل هذه الأبحاث في الفكر العربي قد يعزز من قدرة الشعوب على إعادة النظر في استراتيجياتها السياسية والاجتماعية بشكل نقدي ومفيد.
وفي ضوء كل هذا، يبدو أن الاستشراق والاستغراب ـ كمصطلحين يعكسان حركتين متقابلتين للمعرفة عبر الجغرافيا ـ لم يعودا كافيين لفهم تعقيدات العلاقة بين الباحث والموضوع، ولا لشرح تشابك السلطة والمعرفة والتجربة.
برأيي، تنبثق الحاجة إلى إعادة تموضع جذري: أن نقرأ الغرب، ولكن من مكانٍ غير خاضع له – من الشرق نفسه، بوعينا، وتاريخنا، ومفاهيمنا التي لم تُختبر بعد خارج معايير الاستشراق.
نحن بحاجة إلى اصطلاح/ مفهوم ثالث، يعبّر عن تلك المنطقة الرمادية: حيث لا الغريب غريب تمامًا، ولا القريب قريب بما يكفي؛ مصطلح ينتمي لما بعد الثنائية، لما بعد الشك والغيرة والانبهار أو التعالي.
مصطلح يعترف بأن المعرفة الأصيلة تنبت حين نواجه ذاتنا، لا حين نُعرّفها من خلال مرايا الآخرين.
في النهاية، ما نواجهه ليس مجرد فكرة خاطئة أو اختلاف في الرأي، بل منظومة متكاملة من السيطرة الفكرية تهدف إلى تقييد إرادتنا وفرض واقع زائف. الرهان اليوم ليس على التكيف أو الصمت، بل على المواجهة المباشرة والتفكيك الدقيق لأدوات التضليل. لا مجال للجمود أو الانتظار؛ من لا يبادر لتغيير المعادلة، تتم برمجته كأداة في منظومة لا تعترف بوجوده إلا تابع.
بالنسبة للمصطلح المُراد، اقترح ”التموضع“
في ضوء هذا المسار النقدي المتشعب، يبدو أن “التموضع” ليس مجرد مصطلح معرفي أو إجرائي و ليس مجرد موقع جغرافي أو انتماء ثقافي، إنما بل هو زاوية الرؤية المعرفية والوجدانية التي يقف منها الإنسان ليبني فهمه للعالم، ويؤوّل من خلالها المفاهيم الكبرى؛ إنه موقع داخلي يتشكّل من تراكمات العقد الاجتماعي، والمخيال الديني، والتجربة التاريخية، بما يجعل إدراك الإنسان وتفسيره للواقع انعكاسًا لتركيبه المعرفي لا مجرد استجابة موضوعية للمعطيات.
يأتي هذا التوجه في تماس مباشر مع نقد إدوارد سعيد الذي كشف عن آليات الاستشراق، وامتداده عند جوزيف مسعد وكذلك تحذيرات وائل حلاق من الوقوع في فخ إعادة إنتاج أدوات الغرب في نقدنا له. إن التموضع، إذن، يجب أن يكون رؤية نقدية تجمع بين الوعي بالنزاعات المعرفية وتاريخها، وبين ممارسة عملية قائمة على الجسد والمكان والذاكرة.
هذا التموضع الجسدي المكاني لا يكتفي بنقد الهيمنة والكلونيالية الاستعمارية، بل يرفضها بممارسة ملموسة تعيد تشكيل العلاقة بين الذات والآخر، بحيث يكون صرحاً معرفياً ومنجزاً سياسياً ذا بعد حضوري. إنه يتحول من فعل سلبي ينزع ويستنكر إلى فعل إيجابي يصوغ، يُعيد، وينتج — فذلك هو الفضاء الثالث الحقيقي، حيث يُصاغ التاريخ من جديد، حيث يلتقي الشرق والغرب في صيرورة نقدية، تُحرر المعنى من قيود التبعية وتعيد تعريف الذات خارج الإطار الغربي الاستشراقي والليبرالي الاستعماري.
في النهاية، إنّ تعزيز “التموضع” كممارسة معرفية ومكانية وجسدية، هو مدخل ضروري لتجاوز الاستشراق والاستغراب، وتحرير الفكر من قبضة التبعية الثقافية، وهو أفق نقدي قادر على خلق إمكانات جديدة للوعي والسياسة والتحرير،
وهذا برأيي ليس ترفًا نظريًا، بل هو مفتاح لإمكانية الفهم المتبادل. لأن دلالات المفاهيم تتغيّر بتغيّر الموقع الذي نطل منه على العالم. ومن هنا، فإن أي حوار إنساني لا يمكن أن يبدأ إلا من اعتراف عميق بالاختلاف الجذري في منطلقات الإدراك، لا من ادعاء تطابق موهوم في التعريفات.
هزار حسين
حيفا | فلسطين المُحتلة.