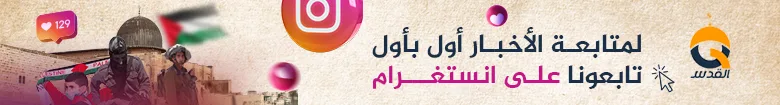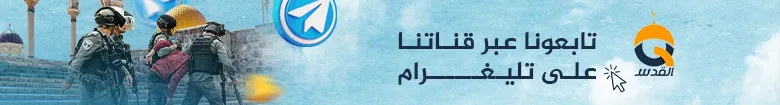معارك مملة

في فترات الحروب أو الأحداث الكبرى، يصبح الخطاب العام مشبعًا بتحليلات متباينة تتراوح بين السياسية الاحترافية وتأملات الجمهور العادي الذي يحاول تفسير المشهد وفق تجاربه الشخصية ومعارفه المحدودة.
هذا الزخم التحليلي، رغم ضرورته لفهم الواقع وإدراك تعقيداته، قد يتحول بالضرورة إلى وسيلة إلهاء غير مقصودة عن الهدف الرئيسي، حيث تتشتت الطاقات نحو تفاصيل جانبية أو خلافات حول مفاهيم يُفترض أنها موحَّدة ومستقرة وفق العقد الاجتماعي أو القومي أو السياسي.
في زمن الفوضى المعلوماتية، تختلط ردود الفعل بالمواقف، وباتَ العك في البديهيات موضةً فكرية، و بتنا نعيش انزلاقًا حادًّا في النقاش العام، حيثُ تبدو أكثر الأسئلة تداولًا – عن الحرية، الأخلاق، الفن، وحتى العدالة – كأنها تُطرح لأول مرة، مع كل جولة من العنف أو الجدل أو الإنتاج الثقافي.
لا يتعلق الأمر فقط بضعف البوصلة الأخلاقية، بل بحالة من الإرهاق المعرفي والجمالي، يتكرّس فيها خطابٌ مشلول، يعيد إنتاج نفسه في استوديوهات النقاش، وبرامج التحليل، وتغريدات الغضب، في صياغات متباينة، تفتقر إلى الجِدّة مثلما تفتقر إلى العمق؛ دون أن تلامس الجذر. وتنتهي إلى لا شيء، سوى مزيد من الضجيج.
مسخ البديهيات
في كتابه صناعة الموافقة، يشير نعوم تشومسكي إلى كيفية استخدام وسائل الإعلام لتحويل التركيز عن القضايا المحورية إلى أحداث جانبية أو تحليلات سطحية تستنزف طاقة الجمهور. ورغم أن تشومسكي يتحدث في سياق الهيمنة الإعلامية المقصودة، إلا أن هذه الظاهرة قد تحدث تلقائيًا خلال الأزمات الكبرى عندما ينخرط الجميع في محاولات تفسير ما يجري. يصبح النقاش حول التفاصيل التكتيكية أو الأحداث اليومية على حساب التفكير في الأهداف الأوسع للعدالة والتحرر وإعادة بناء المجتمعات.
في قلب الإعلام الغربي مثلا، ثمّة نمط متكرّر من “السجالات الأخلاقية”، يدّعي الحياد بينما يعيد إنتاج التعتيم. قضايا تتعلّق بالإبادة، بالاحتلال، بالعنصرية… تُقدَّم على الشاشات كـ”جدل بين رأيين”، وتُختزل إلى مناظرات مكرورة، تُركّز على ما إذا كان هذا الفعل أو ذاك “مبالغًا فيه”، “مبرَّرًا”، أو “مسيئًا” للمشاعر.
في هذا السياق، يضيع التعريف البديهي، يصبح كل نقاش — مهما كانت بدايته عادلة — قابلاً لأن يُفرَّغ من معناه، ويُعيد إنتاج موقع القوة الذي يُفترض به أن يُعارضه.
و هذا توصيف لمشهد عالمي، ساهمت فيه أدوات الإعلام المعاصر، وثقافة الاستهلاك، وتسييس الخطاب الجماهيري، إلى الحد الذي غاب فيه الجدل الحقيقي، وتحوّلت “الاختلافات” إلى عروض جماهيرية تخدم مصالح صانعي المشهد، لا المتضررين فيه.
وليس الإعلام الغربي وحده من يساهم في هذه الحلقة المُفرغة، بل تشترك فيه قنوات ناطقة بالعربية، ومنابر نُقدِّم أنفسنا من خلالها أيضًا.
و من هذا المشهد يمكن قراءة كثير من الأمثلة، بينها الجدل المتكرر حول مقاطعة فيلم أو تصريح أو فنان، لا من باب الاهتمام بالمنتَج نفسه، بل بوصفه فرصة لإعادة فتح حوارات عالقة، لم تُحسم لا معرفيًا ولا سياسيًا. وفي هذا السياق، لا يصبح الفيلم محورًا، بل مرآة تعكس كيف نختلف، ولماذا نختلف، وهل نعي حقًا ماذا ندافع عنه؟
مثال يعكس الكثير من هذا، النقاشات التي رافقت فوز الفيلم (لا ارض اخرى) منذ فترة وجيزة، إذ لم يُطرح السؤال عن دور الفن في زمن المجازر، أو عن حدود الحرية، أو عن المعنى السياسي للتمثيل، بل أعيد تدوير أسئلة مضلّلة: هل نقاطعه؟ هل من حق الممثل أن يُشارك؟ وكأن المسألة تقتصر على “تصرّف فردي” لا على منطق منظومات متراكبة.
بدل أن تكون مناسبة لحوار أخلاقي واضح حول التطبيع الثقافي مع الكيان الاستعماري، انجرّ النقاش إلى دوّامة: هل المقاطعة منطقية؟ هل النقد تحريض؟ هل الجمهور العربي “يُفرِط بالحساسية“؟ هذه الأسئلة هي أدوات تفريغ للوعي، وليست بوّابة لفهم أعمق.
ما الذي يجعل عملًا سينمائيًا يُتهم بالتطبيع؟ وما الذي يجعل مقاطعةً راسخة، ذات بنود واضحة، تتحوّل إلى ورقة قابلة للمراجعة والتحديث كلما لزم الأمر؟ الأجوبة على هذه الأسئلة ليست معقدة، لكنها تكشف مدى هشاشتنا أمام سطوة التبرير، ومدى استعدادنا للالتفاف على المبادئ تحت شعار “الواقعية” و”الحسابات المعقدة”.
لا أرض أخرى… لكن هل هناك خطوط حمراء؟
الجدل الذي دار، وهو جدل مُعاد بالمناسبة، كشف، مرة أخرى، أن القضية ليست فقط في طبيعة العمل نفسه، بل في طريقة التعامل معه، ومنظومة الأعذار التي تُستحضر عند الحاجة.
الفيلم، الذي وثّق معاناة الفلسطينيين من الاحتلال بعيون صانعيه، لم يكن خارجًا عن الرواية الفلسطينية، ولم يكن تطبيعيًا بالمعنى الصريح للكلمة، لكنه فجّر نقاشًا أعمق:
إلى أي مدى يمكن للفن أن يناور دون أن يسقط في فخ التبرير؟ بعض الأصوات قررت أن الحل بسيط وقالوا: “هناك موازنات يجب أخذها بعين الاعتبار”،. وهنا بالضبط تكمن المشكلة، لأن مجرد الحديث عن “موازنات” يعني أن هناك اعترافًا ضمنيًا بأن شيئًا ما ليس على ما يرام. فلو كان كل شيء واضحًا ومقبولًا، لما احتجنا إلى كل هذه “الحسابات الدقيقة” لإقناع الناس به.
في الوقت الذي شهدت حركة المقاطعة (BDS)، خلال الحرب على غزة تصاعدًا غير مسبوق في التأثير والانتشار، حيث نجحت في دفع شركات عالمية لإعادة النظر في استثماراتها، وأجبرت علامات تجارية على الخروج من الأسواق، وعززت الضغوط على الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والثقافية لمقاطعة إسرائيل أو وقف التعاون معها.
من مقاطعة الموانئ في جنوب إفريقيا، إلى سحب الاستثمارات في الجامعات الأميركية، مرورًا بالمقاطعة التجارية الواسعة في الوطن العربي، أثبتت الحركة أنها أداة فعالة في مساءلة الاحتلال اقتصاديًا وأخلاقيًا. وصل النقد لموقفها من الفيلم، إلى حد مطالبتها بتحديث بنودها ومعاييرها، وكأنها مجموعة قوانين تجارية تخضع لإعادة الصياغة وفقًا لمتطلبات السوق! فجأة، لم يعد المبدأ هو الأساس، بل صار المطلوب هو إعادة تعريفه بما يتناسب مع ”المتغيرات”.
وهكذا، يتحوّل الثابت إلى متحوّل، ويتحول الالتزام إلى أمر قابل للمراجعة المستمرة، إلى أن نصل إلى نقطة لا نعرف فيها أصلًا ما الذي نعترض عليه وما الذي نقبله. ومن يفتح الباب أمام “إعادة النظر”، فإنه، سواء عن قصد أو دون قصد، يشرعن بالضبط ما يفترض أن نقاومه.
لا يمكن فصل كل هذا الجدل عن المساحة التي يتحرك فيها الفنانون والمثقفون اليوم. هناك عملية تدجين ناعمة تُمارَس على العاملين في الحقل الثقافي، حيث يُطلب منهم أن يكونوا “واقعيين”، أن يفكروا في “مصلحتهم” و”الفرص التي قد تضيع“.
لا بأس ببعض الالتزام، لكن بشرط أن لا يكون مكلفًا.
هذه الطريقة في ترويض الفنانين والإعلاميين لا تفرض عليهم موقفًا صريحًا، بل تضعهم في حالة دائمة من البحث عن الأعذار، من التوازنات، من الحسابات الدقيقة، حتى يصلوا إلى مرحلة يصبح فيها الموقف المبدئي مجرد وجهة نظر أخرى، لا أكثر.
وهذا هو الجوهر الحقيقي للتطبيع: ليس فقط التعامل مع العدو، بل جعل التعامل معه أمرًا عاديًا، بل وحتى “ضرورة” في بعض الأحيان.
وفي عز هذا المشهد المُربك، والحدود التي ذابت بين الموقف والمصلحة، يخرج الممثل ”الفلسطيني“ جورج إسكندر، بإعلان تجاري لصالح سلسلة “ماكدونالدز” – ابن حيّ المحطّة في مدينة حيفا؛ الحيّ الذي ما زال يئنّ من آثار النكبة، في ذروة الحرب على غزة، وفي لحظة يُعيد فيها الفلسطينيون في كلّ مكان تعريف الأولويات، ويُدفعون إلى العزلة والحصار، حتى يموتون جوعاً.
الشركة التي ترمز اليوم عالميًا لشراكة المال مع آلة القتل، والتي تحوّلت فروعها إلى نقاط إمداد للجيش الإسرائيلي، ومركزًا لمعارك المقاطعة من جنوب إفريقيا حتى بيروت.
لا نغفل طبعا عن ذِكر أن جورج اسكندر فرد من طاقم أوسع؛ إذا ما شملنا باقي الممثلين والتقنيين والفنيين، سنتجاوز ال 18 شخصاً، لكل هؤلاء، بدا الأمر عاديا، لم يجد أحدا منهم ما يستحق موقفًا.
هذا فعلًا رمزيًا فادحًا في توقيته ودلالاته؛ وهو ليس استثناءً، بل امتدادًا طبيعيًا لمسار “التحوّل التدريجي”، الذي يصبح فيه الانخراط في مشهد السوق العالمي، والتواطؤ مع ثقافته الاستهلاكية، لا فقط مسألة خيار فردي، بل نموذجًا يُسوَّق على أنه نجاح وتمثيل وحداثة.
بينما يواصل الالتراس الفلسطيني الاحتفال بكل ما يُلصق بالقضية، حتى لو كان مجرّد لمسة تراث على منتج تجميلي،هكذا جاءت حملة إطلاق زيت الشفاه من هدى بيوتي وسانت ليفانت، التي رغم نواياها الطيبة، ورغم العوائد المنذورة لدعم مؤسسات فلسطينية، ورغم انه الكلمنتينا فاكهة فلسطينية، تبقى تعبيرًا عن التضامن بأسلوب السوق، لا المقاومة.
برأيي، نحن لسنا أمام نقاش حرّ، ولسنا أمام وجهات نظر متباينة. نحن أمام محاولة واضحة لإعادة صياغة الوعي، لجعلنا نعتقد أن “إعادة النظر” في الثوابت هي جزء من النضج السياسي، وأن الصلابة المبدئية ليست إلا نوعًا من الجمود غير المنتج. وهذه هي أكبر خدعة يمكن أن نقع فيها.
المحادثة في هذا السياق ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة لفهم موقعنا الحقيقي في خضم الأحداث، هادفة إلى التعلم والتطور.
والمقاطعة ليست قاعدة قابلة للتعديل، و”الموازنات” ليست سوى تسمية أخرى للتنازل. في نهاية المطاف، الجدالات التي تتكرر خلال الأزمات ليست بالضرورة عديمة الفائدة، لكنها تحتاج إلى أن تُوجه نحو طرح أسئلة أعمق، ما الذي نحاول تحقيقه؟ كيف؟ وما هي الأهداف التي يجب أن نبقي أعيننا عليها مهما كانت الظروف؟ بهذه الطريقة، يصبح التحليل جزءًا من المقاومة الفكرية وليس مجرد إلهاء عن الهدف الرئيسي.
ليس ثمّة ما يدعو للدهشة حين نجد أنفسنا، في عزّ المجازر، نُستدرَج إلى نقاشات متكرّرة تُعيد اختراع البديهيات. البديهيات التي يفترض أن تكون عتبة انطلاقنا، تحوّلت إلى مواضيع جدل لا ينتهي.
لا لأننا نحب النقاش، بل لأن ثمّة ماكينة ضخمة تعيدنا دومًا إلى نقطة الصفر، ما إذا كان الاحتلال جريمة، ما إذا كانت المقاطعة أخلاقية، وما إذا كان الفيلم الفلاني “يتفهّم” الآخر بما يكفي. ولعلّ الأخطر من كلّ هذا، أن نخوض هذه السجالات بنبرة دفاعية، كما لو أنّنا المتّهمون.
لكن الأزمة لا تكمن فقط في الخارج. بل في الطريقة التي نعيد بها إنتاج هذه الرواية، حتى ونحن نحاول مقاومة طغيانها. نُفكّر بلغتهم، نقيس بمعاييرهم، ونُشغّل أدواتهم النقدية التي لا تصلح لتوصيفنا. وهكذا نقف عاجزين عن صياغة موقف حاسم، لأنّنا نسأل الأسئلة الخطأ، هل هذا الفيلم سيئ؟ هل علينا المقاطعة؟ هل نبدو “متطرفين”؟ كلها أسئلة تضيّع الجوهر، وتبقي السجال داخل الحيّز المقبول، بدل أن تعيد مآسسته.
إن ما نحتاجه اليوم ليس إعادة تعريف “الحق” و”العدالة”، بل استعادة تلك المفردات من أيدي من شوّهوها.
نحتاج أن نمشي لغزة؛ لا أن نبقى أعيننا عليها فقط.
هذا الترف والوساع بينما يقول أهل غزة، بعد انقطاع كل رجاء؛ و على مشارف بلوغ الإبادة عامها الثاني؛ دون ثانية واحدة نظيفة؛ وأقتبس عن أنيس غنيمة، وهو صديق غزي ناجي صحيح لحد اللحظة.
”التفكير الذي يلتهمنا يوميًا في البحث عمّا سنسدّ به جوعنا يعادل -دون مبالغة- الجهد الذهني الذي يُبتكر به قنبلة ذرية في نهاية المطاف. كم الأشياء المتقلبة المجبرين على مواجهتها معها مرهق إلى حد لم يحدث في العالم إرهاق مثله، إنه مثل تعب ومشقة وإعياء وتهالك و ضجر وكلل ووهن وضيق يدورون في دائرة واحدة، يؤدي إلى أن يكون الشخص منّا منهك لآخره.. حتى قبل أن يستيقظ بعد. أتعرف الحرب؟ نعم تمطرنا القذائف كل لحظة وكاذبٌ كل من يدّعي أنه اعتاد على هذه الوحشية. لكن، هل سمعت عن الحرب حقًا؟ إنها أكثر في هذه التفاصيل، أي عندما تتقاسم عائلة الرغيف، وعندما تجبر أم على أن تذهب نحو مصائد الموت لإطعام أطفالها بعد قتلهم لزوجها.. ثم لا تعود“.
نحتاج أن نعيد تثبيت البديهيات لا باعتبارها محلّ جدل، بل كأرض صلبة ننطلق منها لنفكّك الأكاذيب، لا لنُقنع أنفسنا أولًا بأننا على حق. المسألة ليست في المقاطعة، ولا في الفيلم، بل في قدرتنا على تحرير وعينا من حاجته المستمرة إلى “الاستئذان”، وفي قدرتنا على تسمية الأشياء بأسمائها.
– كل سبعين كيلو، شهيد –
هزار حسين
حيفا | فلسطين المُحتلة.