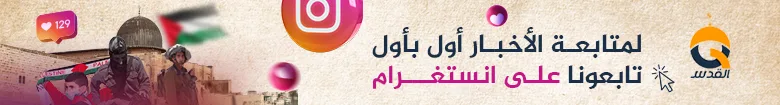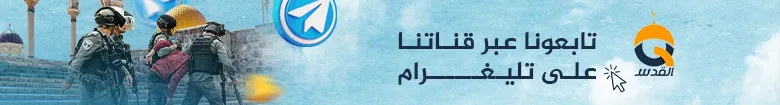الشرق المتجدد والغرب المأسور

مسلسل Adolescence؛ هو دراما بريطانية مكونة من أربع حلقات، صدرت على نتفليكس في 13 مارس 2025. تحكي القصة عن جيمي ميلر، فتى يبلغ من العمر 13 عامًا يُعتقل بتهمة قتل زميلته في المدرسة، كاتي. حظي المسلسل بإشادة نقدية واسعة، حيث وصفته بعض المصادر بأنه “تحفة فنية تقنية”. كما أنه أثار اهتمامًا عالميًا، حيث تم مناقشة عرضه في المدارس البريطانية لتعزيز الحوار حول الصحة النفسية للمراهقين.
في عالم يُروّج فيه للانفصال كتحقيق للذات، يقدم Adolescence لحظة صادقة، تقترح – ربما بلا قصد – أن الرابط هو الخلاص؛ أن الخروج من الدائرة لا يعني شيئًا إن لم نعرف كيف نعود.
ما الذي تعنيه العدالة في منظومة تصنع الجاني قبل أن تمنحه المحاكمة؟
قليلة هي الأعمال الدرامية التي تُمسك بتلابيب المأساة دون أن تبتذلها، وتُمرّر الألم بلا تهويل ولا تزييف.
هذا المسلسل هو واحد من تلك المواد البصرية التي اختارت أن تهمس حيث يصرخ الجميع، وأن تبني توتّرها بالصمت، لا بالضجيج، كاميرا تتحرك كأنها تتنفس، مشاهد مصوّرة بلقطة واحدة تجعل المشاهد في قلب الحبس، في قلب الذنب.
بأداء تمثيلي بارد كرصاصة، وإخراج يعرف متى يصمت ليترك المشهد ينهار وحده.
حين تلد الليبرالية وحشاً وتمضي
برأيي، هذا ليس مسلسلاً عن طفلٍ يقتل زميلته. هذا مسلسل عن حضارةٍ تقتل أبناءها ثم تبكي عليهم في النشرات.
ليست دراما نفسية فقط، بل محكمة مفتوحة، يُستدعى فيها الجميع: العائلة، المدرسة، الإنترنت، الدولة، والقيم الغربية الليبرالية التي تُقدَّم كمنقذ، بينما هي في الحقيقة الجاني الأول.
في قلب الحدث يقف جيمي ميلر، طفل الثالثة عشرة، لا كقاتلٍ وحيد بل كنتاج دقيق لمصنع حديث ينتج الغضب.
ما يفعله المسلسل، دون مواربة، هو خياطة الجريمة الكبرى بخيوط نظامٍ يُحاكم فيه الطفل على الطعنة، بينما يُبرَّأ الهيكل الذي أعطاه السكين.
الكاميرا كلحظة محاكمة
منذ اللحظة الأولى، يُعلن Adolescence تمرّده على قواعد الدراما المعتادة. لا تقطيع، لا قفزات زمنية، لا راحة بصرية. الكاميرا تسير بخطى بطيئة، خافتة، لكنها قاتلة. كل حلقة تُصوَّر بلقطة واحدة متواصلة، بلا فواصل، كأنها شهيق طويل لا يُسمح لك فيه بالزفير.
لكن ما يبدو تقنية سينمائية جريئة، هو في الحقيقة موقف فلسفي واضح: الزمن لا يُقطع، الألم لا يُمنتَج، والواقع لا يُجمَّل.
الكاميرا لا تراقب فقط؛ بل تُشبه العين الداخلية لجيمي، أو أعيننا نحن كمجتمع يشهد لكنه لا يتدخل. وكأن اللقطة الطويلة تقول لنا:
”كنتم هنا، كل هذا حدث وأنتم تتابعون.”
في مشهد اعتقال جيمي، لا وجود للموسيقى، لا للصراخ، فقط خطوات رجلي شرطة وهم يصطحبون طفلاً مطأطئ الرأس. لا دموع درامية، بل صمت يتكثّف حتى يخنق. الكاميرا تتراجع ببطء، كأنها تخجل. لكنها لا تُغلق الباب. تبقيه مفتوحًا على امتداد ثلاث عشرة سنة من العجز الأبوي، التفلّت المدرسي، والانفصال المجتمعي.
هذا عمل لا يُشاهَد بل يُفكَّك.
– من أول مشهد، نعرف أن القصة ليست عن “من فعلها؟” بل عن لماذا كلّنا سمحنا لها أن تحدث
يرفض Adolescence أن يمنحنا اللقطة السهلة أو الخروج الآمن. يفرض علينا أن نعيش كل لحظة كما عايشها جيمي وأهله. كأننا نحن من يُستجوب. وهنا يكمن الاتهام الحقيقي: ليس السؤال “من قتل كاتي؟”، بل “لماذا كلنا تركنا جيمي يصل إلى هناك؟“.
يُستخدم الفراغ البصري ببراعة: غرف واسعة لكن باردة، ممرات طويلة لكنها صامتة، مدارس بلا لون، منازل بلا دفء. كل مشهد يذكّرنا أن القتل لم يحدث فجأة، بل في كل مرة تُرك الطفل فيها وحده أمام شاشة، أو خلف باب مغلق، أو تحت عين تتغافل.
لكن وسط هذا الإتقان الفني والجمالي، لا يمكن إلا أن نرى ما هو أعمق من القصة؛ مأساة لم تولد من فراغ، بل من رحم منظومة.-
حين يُخلق القاتل من الشاشة / والغرب يدفع ثمن استقلاله كاش
يكشف المسلسل جريمة يرتكبها عالم يعبد الفردية، حتى لو أكلت أبناءه.
فجيمي لم يقتل لأنه وحش. قتل لأنه ولد في فراغ عاطفي، في صحراء تربوية، وتحت طوفان من الصور والمفاهيم المختلة عن الرجولة، والعلاقات، والقيمة الذاتية.
جيمي ميلر، ابن الثالثة عشرة، لا يظهر كجاني بل كضحية نهائية لمسار طويل من القطيعة: بين الابن ووالده، بين الطفل ومدرسته، بين الفرد ومجتمعه. هكذا تبدو الحرية حين تُفرَغ من روابطها الإنسانية: قرار شخصي في الظاهر، ووحدة قاتلة في العمق.
المسلسل برأيي، لا يُدين جيمي، بل يُدين مجتمعاً يخلط بين الاستقلال والعزلة، بين الحرية والفراغ، بين التربية والحياد.
هذه ليست قصة عن انحراف فردي، بل عن مجتمعٍ قرر أن “ينسحب” من مسؤولياته.
يقدم مستقبِل لمنظومة كاملة من الاختلالات الثقافية.
“الإنسل” ليس مجرد مصطلح، بل تشخيص دقيق لعطب اجتماعي يمسّ الذكور تحديدًا حين تُترك فطرتهم الأخلاقية بلا توجيه، وبلا حنان.
الإنسل (incel)، المفهوم المتسلل في خيوط الحكاية، ليس مصطلحاً عابراً. هو مفتاح لفهم جريمة لا يليق بها تفسير فردي. في هذا العمل، الطفل كناتج ثقافي-رقمي لعالم حفر الكراهية داخل الهوية ذاتها.
على أهمية كل ما سبق، إلا أن أكثر ما لفت نظري في المسلسل كان نهايته. تلك اللحظة التي وجدت فيها العائلة نفسها أمام مفترق طرق: هل تغادر البلاد بسبب ضغط اجتماعي ساحق؟ أم تبقى وتواجه، وتعيد بناء ذاتها رغم التصدع؟ قرارهم في النهاية بالبقاء كان مطمئنًا، بل ربما مريحًا للمشاهد، لكنه في جوهره لم يكن هو ما استوقفني. ما استوقفني فعلًا هو مجرّد أن هذا السؤال طُرح أصلًا: هل نرحل أم نبقى؟
هذه المسافة التي تفصل بين الإنسان ومحيطه، بين الفرد وجذوره، بين الذات والعائلة، هي ما أثار قلقي. ففي الثقافة الشرقية، لا يُطرح هذا السؤال بسهولة؛ البقاء ليس خيارًا نُقلّبه، بل هو امتداد طبيعي للانتماء، وللروابط التي تُلزمنا وتحمينا في آن.
حين تتنكر الحرية لأصلها، ويُترك الإنسان وحده
في المشهد الختامي، تتخذ العائلة قرارها بالبقاء قرب جيمي. هنا يظهر التوتر العميق بين العقل الغربي والفطرة الشرقية. في الغرب، يُنظر للبقاء على مقربة من من نحب كـ”تضحية غير حتمية”. أما في الشرق، فهو وفاء، وواجب.
يُقدّم المشهد وكأن العائلة سجينة ارتباطاتها العاطفية. لكنه يغفل عن حقيقة أعمق: هذه الروابط ليست قيداً، بل مقاومة ضدّ تفكك إنساني عميم.
في المجتمعات الشرقية، يُعد الالتزام بالعائلة طوق النجاة. تضع القيم الدينية والاجتماعية هذا الولاء في مكان مقدس، يُتوقع من الفرد أن يضحي بهويته الشخصية ورفاهيته من أجل العائلة؛ ويُرى بذلك أعظم أشكال الحرية.
“Freedom without connection is merely the right to disappear.” — Michael Sandel, Harvard philosopher
هذه فكرة مستمدة من المعايير الدينية والاجتماعية التي تؤمن بأن العائلة هي المصدر للهوية.
في المقابل، نجد أن الغرب يتعامل مع العلاقة الأسرية من منظور مختلف. هناك مساحة للفردية، حيث يمكن لأفراد العائلة أن يُعيدوا تقييم مكانهم في العالم، ولا يُتوقع منهم التزام دائم بالبقاء ضمن دائرة واحدة.
المسلسل، بخطابه الملتبس، يُقدّم الخيارات الحتمية بشكل يلتقط التوتر بين الحنين الأسري وبين الحاجة للهروب. لكن، الحقيقة التي يُخفيها هذا الخطاب الرومانسي عن البقاء، هي أنه الإلتزام الأسري؛ أمر واجب وليس أمر جائز؛
المفارقة / الغرب في رحلة بحث عن ذاته.
ما يظهر في Adolescence من دعم للأخت بضرورة البقاء حول الولد يعكس إشكالية كبيرة؛ فما يُقدّم كـ”رغبة نبيلة” للبقاء إلى جانب جيمي، يُخفي ورائه امكانية تركه لمواجهة مصيره، بينما يبتعدون هم عن الضغط الاجتماعي.في حين أن ”البقاء“ من “القيم الاجتماعية” التي يتمسك بها المجتمع الشرقي.
هذه المقارنة النقدية بين الشرق والغرب، وبين الولاء والحرية الفردية، توضح الفرق الجوهري في فهم Adolescence للهوية البشرية في كل بيئة اجتماعية.
في العقد الاجتماعي، يرى جان جاك روسو أن الحرية الحقيقية لا تُمارس إلا ضمن روابط اجتماعية تُبنى على المسؤولية والالتزام المتبادل. يقول:
“الإنسان يولد حراً، ولكنه في كل مكان مكبل بالسلاسل“.
إلا أن السلاسل هنا في الشرق، ليست قيوداً سلطوية، بل التزامات أخلاقية تشكل نسيج المجتمع.
في المجتمعات الشرقية، هذه “السلاسل” هي العائلة، القرابة، الجيران، اللغة، الدين. بينما في النموذج الليبرالي الغربي، يتم تفكيك هذه الروابط تدريجيًا لصالح “حرية الفرد”. لكن ما لا يُقال هو أن هذا الفرد يصبح هشًا، معرضًا للانهيار، غير محمي في لحظة الأزمة.
المفكر الكوري الجنوبي بيونغ تشول هان، في كتابه”مجتمع التعب“ (The Burnout Society)، ينتقد هذا النمط الغربي ويصفه بأنه
“حرية مفرطة تؤدي إلى عبودية ذاتية؛ إذ يُجبر الفرد على أن يكون مشروعاً قائماً بذاته، بلا دعم، بلا روابط، بلا حضن“.
ويشير وائل حلاق إلى أن المجتمعات الشرقية، رغم طابعها المحافظ، تملك ما أسماه بـ”أخلاق الانتماء”، حيث تتجلى الحرية لا في الانفصال، بل في الوفاء.
بين الإلزام الشرقي والحرية الغربية
حين تصبح الحرية سجنًا ناعمًا
ماذا نختار؟ حرية تهجرنا حين نسقط، أم روابط تبقينا على قيد المعنى؟
بينما تأتينا حلقات المسلسل من أزقة لندن، وفي مشاهد صُممت بعناية لتعكس واقع المراهقة في المدينة الحديثة، يضعنا مسلسل Adolescence أمام مرآة تُظهر لنا ما يحدث عندما تتحول “الحرية الفردية” إلى انعزال أناني مغطّى بلغة الاختيار والقرار المستقل.
هذة أزمة فلسفة اجتماعية كاملة؛
كيف يُمكن للفردانية المفرطة أن تنتج جيلاً مُشوَّشاً
لا يتحدث المسلسل عن “مراهق” كما يوحي العنوان، بل عن مراهقة ثقافةٍ كاملة، تؤمن أن الفرد هو القيمة العليا، حتى ولو على حساب الآخر.
ليست مجرد قصة عن جريمة فردية، بل هو مرآة لثقافة تعيش على التناقضات، بحيث تُقدّم الحرية الفردية كقيمة عليا، بينما تبقى ضحايا هذه الحرية هم المجتمع وأفراده.
في زمنٍ يُروَّج فيه للفردانية كذروة التنوير، يأتي هذا المسلسل كمرآة عاكسة لانهيارات هذا التنوير حين يُدفَع إلى حدوده القصوى.
على النقيض، فإن الرابط الذي تتمتع به المجتمعات الشرقية، وإن بدا أحياناً تقليدياً أو حتى مقيداً، إلا أنه يمنح الإنسان شبكة أمان عاطفية تمنعه من السقوط الحرّ؛
من هوبز إلى شارل تايلور
-العقد الاجتماعي-
في كتاب Leviathan، صاغ توماس هوبز مفهوم العقد الاجتماعي كأساس للشرعية السياسية، حيث يتنازل الأفراد عن بعض حرياتهم لحماية أنفسهم من الفوضى. بينما جون لوك لاحقًا أكد على الحقوق الطبيعية للفرد. غير أن الفيلسوف الكندي المعاصر شارل تايلور، في أعماله حول “السياسة والاعتراف”، يحذّر من نسخة متطرفة من الليبرالية التي ترى الفرد ككيان مكتفٍ بذاته، مستقل تمامًا عن الآخرين، ويعتبر هذه الرؤية “تغريبًا للهوية الإنسانية”.
الروابط الشرقية: ولاء لا يُدرَّس في كتب الليبرالية
تحتفظ الثقافة الشرقية بمفهوم مختلف للعلاقة مع المحيط؛ لا يراها قيدًا بل هوية.
فالإنسان الشرقي، منذ أن يبدأ بتشكيل ذاته، يتعلم أن العائلة هي الحاضن الأول له، وبهذه الرؤية فهي ليست مجرد علاقة شخصية، بل هي جزء من الهوية الأكبر التي لا يمكن التفريط فيها، ويعتبرها نواة الهوية وركيزة الوجود، الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء.
نفس المفهوم الذي يُنظر فيه إلى العائلة، يُنظر فيه إلى الوطن. فكما لا يمكن أن يُفهم الشخص بدون العائلة، ذات الحال مع الوطن.
في زمن العقود الاجتماعية الهشّة، والسياسات النيوليبرالية التي تسلّع حتى العلاقات الفطرية، يصبح التمسّك بالروابط فعلًا مقاومًا. مقاومة للزمن البارد وللأفكار الفارغة.
هذا المفهوم للعلاقات والمسئولية، هي ما يميز الشرق في نضاله ومقاومته، لأن الدفاع عن الوطن هو استمرار للروح التي تسكن في قلب العائلة، والتي لا يمكن أن تُفهم إلا من داخل هذا الإطار.“
يُعلّمنا الشرق — رغم كل ما فيه من تناقضات — أن في التعلّق نجاة، وفي الالتزام عزّة، وفي البقاء واجب.
هذا لا يعني تمجيدًا أعمى للشرق أو شيطنةً مطلقة للغرب، بل دعوة لإعادة التفكير: هل الحرية تعني أن نختار أنفسنا دائمًا؟ وهل التحرر هو أن ننسى من وقفوا معنا حين لم نكن نعرف أنفسنا بعد؟
متى تتحول الحرية إلى عبء؟ ومتى يصبح القرار المستقل، في جوهره، هروباً أنانياً من المسؤولية تجاه الآخر؟
إلى أي مدى يمكن للحرية الفردية أن تُبرِّر التخلّي؟ أين ينتهي “الحق بالاختيار” ويبدأ “الواجب الأخلاقي تجاه الآخر”؟
هزار حسين
حيفا| فلسطين .